تعاني دول ما يسميه الغربيون ب (العالم الثالث) من تحديات كبيرة يتصدرها الإرهاب والنزاعات الداخلية المدفوعين بشحنة التخلف المنبثقة عن غياب سياسة محكمة تراعي أهمية التعليم في بناء حضارة راقية، قادرة على منافسة الحضارات الكونية من جهة والتجاوز بشعوب هذه الدول عن جسر التبعية نحو فضاء تقرير المصير من جهة ثانية.
في قطرنا: موريتانيا الذي يدخل ضمن التصنيف الآنف، بالتمثيل العربي الإفريقي، يعاني هذا الحقل المركزي، التعليم، منذ تأسيس الدولة الوطنية من إهمال مفرط ليس على مستوى المعدات المادية، من مباني وأدوات تقنية، فحسب وإنما ،وهو الأخطر، على مستوى المقررات والمنظومات والمناهج، وصعودا نحو قمة الخطر، على مستوى تكوين الكادر البشري المسير والمدرس.
وعلى رغم ما عرفته البلاد مما شيع مجازا بالإصلاحات التعليمية، التي أشبه ما تصف به أنها، محاولة ترميم غير موفقة، ظل التعليم هو عائق الدولة عن مسايرة الركب الحضاري. وأجبر هذا التعليم بدافع التمصلح على أن يظل بؤرة توتر بين مكونات الشعب الذي يجمعه التاريخ والمعتقد ووحدة المصير، واتخذت اللغة الرسمية، لغة الدستور، لغة الدين الواحد، اللغة العربية وسيلة لتغذية ذلك التوتر، حيث صنفت على أنها لغة تخص العنصر العربي في مقابل اعتماد لغة المستعمر، اللغة الفرنسية، لغة الشرائح الزنجية في البلد! وبذلك قسم المجتمع إلى ناطقين بالفرنسية (Francophones ) وناطقين بالعربية (Arabophones)! وفتحت جبهات النزاعات على مختلف الأصعدة بدل المحبة والتآزر.
وفي الحقيقة لم يكن للشرائح الزنجية في هذا التحديد أي دور قصدي إلا المنتسبون منهم للفئة(أ) الفرانكفونيين التي يمثل العرب من منتسبيها نسبة70 % أما السواد الأعظم من الزنوج فيدخل ضمن مجموع الفئة(ب) (عربوفون) لأنهم منذ قرون أسلموا إسلاما كليا تقتضي متطلباته معرفة لغة الإسلام، اللغة العربية .
ولأن المتعربين هم السواد الأعظم من المجتمع، سواء منهم العرب أوالزنوج، وبما أن المتفرنسين يمثلون الجالية الفرنسية في موريتانيا على صعيد الثقافة، لم يفي التعليم بمطلوبه المناسب، حيث استحوذت القلة على المصالح الحيوية وإقصاء الغالبية. ولإضفاء الشرعية على هذه الفعلة، وهمـًا، ألبسوها ثوب التكيف مع متطلبات المرحلة مدعين أن العربية لا تناسب العلوم التقنية ، متجاهلين أن اللغة أي لغة تسمى العلم المساعد ولا تقف أي لغة في وجه أي علم سواء كان تقنيا أو أدبيا. ثم إن مسألة التوظيف احتكرت على المتفرنسين لأن فرص العمل فصلت على ذلك الجسم الغريب، وبدل اعتماد الأولوية للمتعلمين بلغة الدستور، لغة الدين كادوا يُقـْصون من المشاركة وتعويضهم بناس لا يفقهون شيئا، لا بالفرنسية ولا بالعربية لأن التحكم في توجيههم أسهل على المتمصلحين من التشاور مع النخب المتعلمة بالعربية!. وهؤلاء المتخلفون ومنظروهم المتفرنسون، هم الذين تولوا تدبير أمور الدولة منذ استقلالها.
إضافة إلى ذلك تم إعطاء أولوية التشجيع لكل مراكز الدولة على حساب المؤسسات التي لها علاقة بالهوية والحضارة لأن القاصد لا يريد حل مشكل وإنما تكريسه، فهمشت مؤسسة التعليم الأصلي كخطوة أولى ثم العصري كخطوة ثانية ووصم المدرسون بوصمات الاحتقار، حيث أجبروا ، بعامل التمرن، على قبول المذلة أمام المادية البدائية لدرجة أصبح معها المعلم الذي"كاد أن يكون رسولا" ينظر له في المجتمع بنظرة البؤس. ولذلك ابتعد خيرة المتعلمين عن امتهان التدريس وخصص للفاشلين فتزايد عددهم في وتيرة متصاعدة لم يعرفها أي بلد في العالم.
هذه المعضلات الناجمة عن تلك السياسات تعززت بخطورات أخرى تتصدرها فوضوية التعليم الحر لدرجة أصبح معها الأجانب مدراء مدارس يؤطرون أبناء الوطن!، إضافة إلى سلبيات العولمة المتمثلة في ظهور الأجهزة المحمولة، متعددة الخدمات التي تسمح للمتكاسل بإعداد ورقة إجابة تنافس من قضوا أوقاتهم في تحصيل المعارف، بل التفوق عليهم أحيانا وتزايدت أعداد الناجحين بهذه الوسيلة خاصة على مستوى باكلوريا الذي كان يمثل العقبة الوحيدة التي لم يتجاوزها إلا مثابر مجتهد أو مختلس بارع. ولم ترسم الجهات المعنية بعد سياسة واقية من شرهذا الداء الفتاك.
مخرجات بليتوز تلج أروقة الجامعة وتنافس المثابرين بنفس الواسطة لأن الفضاء الجامعي رحب لمثل هكذا ممارسات، البحوث تعد في الوراقات ويساعد فيها الزملاء المجتهدون.
الذي كان يميز المراحل المتقدمة من تاريخ المنظومة التربوية هو أن ولوج مدارس تكوين المعلمين والأساتذة كان يترتب عليه توفر المتسابقين على مؤهلات تسمح لهم بذلك الولوج.
ما طرأ في المرحلة الحالية هو أن الشيخ بليتوث تعهد لتلامذته أنه سيشركهم في سوق العمل. ويبدو أنه نسق لبلوغ ذلك مع المعنيين، وفضلا عن إعطائهم فرصة كبيرة في مسابقة الاكتتاب، التي ستخضع لتكوين يأخذ وقتا، من خلال تقاضي المراقبين عنهم وعدم تركيز المصححين على أوراقهم لتميزها عن العمل المنبثق من مخزون معرفي ينطلق من ذهن نظرائهم المنافسين، فضلا عن كل هذا أعطيت للشيخ المذكور فرصة تاريخية يدمج من خلالها مخرجاته في سوق العمل، حيث فتح باب التعاقد على مصراعيه ومكن ذلك بليتوث من الاتصال بمختلف المدراء الجهويين وإيداع ملفات دفعاته لديهم، تلك الملفات التي تبدو نالت إعجاب أولئك المدراء فاعتمدوها على حساب كل المخرجات.
الشيئ الغريب في هذا الطارئ هو أن الصفقة التي أبرمت بين المدراء الجهويين ومدراء مدارس التكوين مع بليتوث تمت في شكل استباقي مع خطاب السلطة العليا لافتتاح السنة الجديدة 2015 الذي تم التركيز فيه على اعتبار هذه السنة، سنة تعليم فهل يعني ذلك أن أصدقاء هذا الوسيط شعروا باقتراب مهلته وبادروا لإسعافه بما يستطيعون قبل فوات الفرصة؟ أم أن الخطاب الرسمي يعني أن هذه السنة هي سنة قضاء على التعليم بإدماج مخرجات شيخنا المذكور ضمن المؤطرين والمربين، بل وتصدرهم قائمة المستفيدين من هذه الوظيفة العمومية كما لمحت لذلك بعض الصحف الساخرة في البلد؟ الاحتمالات مفتوحة!.
في كل الأحوال يجب على أهل الحل والعقد إن كانوا صادقين فيما يقولوا بخصوص التعليم أن يهتموا بمؤسسات الاكتتاب لأنها مسرح للعلاقات الاجتماعية ولا تمت لأي صلة بالمهنية . وفي هذا الإطار نقترح لهم ما يلي:
ـ تجنيد مراقبين استخباراتيين على غرار ما يتخذ لمتابعة أصحاب الرأي، ينقسمون إلى: مصححين يراقبون التدخلات بواسطة الإشارة المكتوبة، وفنيين يكون هم الوحيد متابعة سكرتيريا إدخال النتائج التي تتم من خلالها













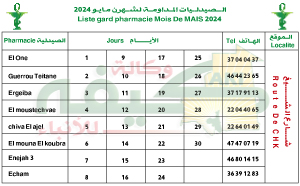

 منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
 ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟
ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟
 شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
 كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
 الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
 لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
 مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار
مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار