ما هو السر يا ترى وراء تأخر البلد عن ركب الأمم؟ و ما هو السر في وجود حاجز سميك و نفور مرضي و عقد متداخلة بين أهله و بين مظاهر التصنيع التدريجي و التحويلي الأولي منه على الأقل لتأمين اكتفاء ذاتي من الضروريات الخفيفة كالمواد البلاستيكية، الأواني، الأفرشة، المعدات الكهربائية، مواد بناء، صناعة الملابس، تعليب الأسماك و التمور و منتجات زراعية أخرى، إنتاج الأدوية: مسكنات، معقمات، مضادات حيوية و عقاقير للإلتهابات، إلخ... مطبوع عليها صنع في موريتانيا؟ ثم كيف لبلد يمتلك مثل ما تزخر به أرضه من مقدرات في تنوع مذهل أن يظل أهله مُستنزِفِين هذه المقدرات لحساب و بفعل غيرهم في مقابل استهلاك عشوائي من المستورد محدود الحيز الزمني و عديم الوقع الإيجابي على مستوى العيش و ديمومته؟
إن كل المؤشرات و المعطيات العلمية و المعلومات الموضوعية و الدلائل الحسابية تثبت أن موريتانيا تملك عددا مريحا من الأطر السامية و الكوادر الفنية و الكفاءات العلمية المتخرجة في أكبر الجامعات و المعاهد و المراكز العلمية و الحرفية العالية في عديد من دول قارات العالم وعلى التراب الوطني على الرغم من حداثة العديد من المدارس و المعاهد و الكليات. و هو التراكم الحاصل على فترة تزيد سنين أربعة على الخمسين من الأعوام و شكل أجيالا ثلاثة لا تخطئها العين المجردة، إذ هي ما تزال في حيز شرائح الأعمار المترابطة تتعايش في شبه يفترض لها أن تكون متناغمة مهنيا، متكاملة في تدرج حرفي يجمع التجربة الرصينة و العلمية الثاقبة المجددة بسيل الابتكارات العرم من حولها. كما أنها الأجيال التي كانت لتشكل بهذا الحضور الطافح مددا إلى المستقبل لا يستهان به و الذي ما كان - لو قيد لقادته الفكريين و السياسيين و العلميين والمخططين أن عملوا بوعي و وطنية و إخلاص على ذلك - إلا ليطفئ ظمأ البلد إلى سقاية العلم و تطبيقاته على أرض الواقع و تلبيته الفورية لاحتياجات دولةِ مواطنيهِ الناشئة بعددهم سهل التوجيه و الذي لا تكلف عملية تأطيره للوجهة الصحيحة كثير عناء، ثم الاستغناء به حضورا و طاقة وطنية تغني باستغلال مقدراته من التواجد المحرج للخبرة الأجنبية و ما يترتب عنها من لجوء مقيدٍ إلى وسائل دولها العملية و العلمية و التوجيهية.
إن عدد المهندسين الموزعين في البلد على كل خارطة الاختصاصات و الاحتياجات ذات الصلة بمقدراته و متطلبات التنموية الشاملة والرفع من مستوى المواطن، عدد كبير نسبيا و يغطي كل المجالات الحيوية كالمياه و الزراعة و الثروة الحيوانية و البحرية و المعادن و الهندسة الميكانيكية و الطاقة الكهربائية و غير ذلك كثير مما يجد لتطبيقاته مجالا متعدد الأوجه و مطلوبا بإلحاح دفعا لعجلة التنمية الاقتصادية و بناء الإنسانٍ العصري. و إن عدد الإداريين الملمين نظريا بما يكفلُ رفع الأداء في إطار "الحكامة الرشيدة" و كل تحديات الفوضى و ثبات النظام، عدد كاف و يزيد لإكمال المهمة و إرساء قواعد المدنية و الحداثة. و ليس عدد المسيرين و الخبراء و المخططين في مجالات التنمية و تسيير المقدرات بأقل في العدد من الحاجة قياسا بحجم المتطلبات، مثل ذالك من التقنيين و الأطباء و الحقوقيين قضاة و محامين، منظرين، مجتهدين، معدين و صائغين للقوانين لكل الحالات و في كل المجالات. و إنه لو تم القيام بالإحصاءات التقييمية و التقويمية والضرورية لكل هذه القدرات و الطاقات من جهة و الاحتياجات التي يعبر عنها الواقع و المتطلبات من جهة أخرى لمالت الكفة إلى حقيقة أن النقص ليس في الأعداد و الاختصاصات، إذ كيف يعقل أن لا يكون الأمر كذلك و التكوين جاري منذ عهد الاستعمار إلى فترة الاستقلال و التحرر من طوق غياب الدولة المركزية و التوجيه الاستعماري و التبعية الإقليمية جنوبا و شمالا، إلى غاية فترة شمولية الوعي النظري الذي ساهمت فيه التيارات التحررية و الأيديولوجية القومية و الاشتراكية و العلمانية و الرأسمالية و العقائدية.
فأين إذا يمكن البحث عن أسباب هذا التناقض الصارخ و الحالة الشاذة بمقاييس الموضوعية المجردة بين حضور الكادر ماديا و غياب النتائج العملية التي من المفروض منطقيا أن تترتب عنه على أرض الواقع؟ هو سؤال يطرح نفسه منذ نشأة الدولة و لما لم يجد بعد جوابا فإن الأمر قد ولد بالنتيجة سؤالا ملحا ليست الإجابة عنه بأقل من ضرورية و مؤكدة حتى لا يبقى الحاضر رهن غموضه و المستقبل في دائرة شك حصوله: أين بيت قصيد هذا الوضع الاستثنائي؟
أفي العقلية التي تقف حائلا أمام التمتع عمليا بالكفاءات و نتائج العلوم التي حصلها الأفراد و بقيت في دائرة الاعتبارات النظرية كأوسمة أو نياشين تزين الجبين القبلي و الطائفي و الإثني ليس إلا؟
أم هي عوامل أخرى تقف حائلا أمام السير بالبلاد إلى مصاف الأمم و تبرير أسباب بقائها و استقلالها، عوامل منها غياب الوازع الوطني الذي يغار به كل فرد على الكيان العام في الصميم و يحميه في الواقع؟
أم هو غياب مفهوم الدولة في دائرة رفض التخلي عن الكيان الجزئي وطنا يموت دونه البلد الموحد؟
أم أن ثمة عوامل أخرى تحتاج إلى التشخيص النفسي و التحليل الانتربولوجي؟
و مهما تكن الإجابة التي لا بد من الوصول إليها في حتمية المسار التاريخي إن عاجلا أم آجلا، فإن الوضع القائم في البلد، المتسم بالركود الحضاري و بالبعد عن الالتحام بواقع العصر منطقيا و عمليا، لا يوازيه إلا ما يعيشه الشعب من انفصام عن واقع التغيير و بناء المستقبل. فلا يختلف القادم من أعماق البلد - في التفكير و الطموح المحدود و الفهم الضعيف لمتطلبات الوطنية في أبجدياتها و في تخلفه و عجزه المفضوح عن استخدام لغة العصر و وسائله و وسائطه التوضيحية لفوائد التقدم - عن أخيه المتعلم المستقر في المدن الكبرى و هو الذي يكتفي بالقشور السهلة و يحن في انفصام شديد إلى العمق بكل تفاصيل مصاعبه الجمة و مصائبه الكأداء.. وضعية نفسية مزمنة لا بد من شحذ الهمم و الإقدام على محاربتها سبيلا إلى تخليص المواطنين من براثنها، الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال مكافحة سدنة هذه الوضعية من مثقفين نظريا و أطر بالتحصيل و سياسيين هزليين و قادة يطوقهم و يشلهم المنطق الإقطاعي الذي يحاصرهم في الواقع و في الصميم، حتى تزاح الغمة و يتسرب نور الوعي القيم المصحوب بإرادة و فعل العمل البناء.
و يبقى من السخرية بمكان أن نستمر في دغدغة عقولنا المتحجرة بمواويل التغني و التباهي بأمجاد مات أهلها و بصفات المثالية و الكمال في العلم و الشعر و النبوغ و الريادة و الإقدام في ظل هذه الوضعية المنفلتة من قبضتي المكان في حيز القرية الكونية و الزمان في دائرة التحولات المذهلة في التفكير و العمل، و لا نرى وقع ذلك في صرح البناء و التقدم و الازدهار و اشتداد عود الكيان الذابل.
فإلى متى إذا ستظل جعجعةُ كبرياء شخصيتنا "الدونكشوتية" تصم آذاننا و لا نرى طحين علمية الواقعية الاضطرارية يصنعُ لنا خبزَ بقائنا في عصر الوجود المقرون بالعطاء؟













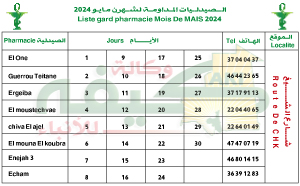

 منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
 ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟
ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟
 شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
 كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
 الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
 لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
 مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار
مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار