لقد تناولت في الجزء الأول من مقال سابق، تحت نفس العنوان، مفهوم التمييز الإيجابي من حيث الدلالة و القانون و ضرورة تطبيقه من أجل الرفع من شأن فئة عريضة من مجتمع البيظان تخلفت عن الركب بإرادة مجتمعية تستحق التعويض عنها. إن هذا التميز سيكون صمام أمان لوحدة و تماسك هذا الوطن. و لكي لا أطيل على القارء في الكلام المرسل و كما وعدت سابقا، سأتناول التميز الإيجابي في مجال التعليم، نموذجا. إن أهمية التعليم مسألة لم تعد اليوم محل جدل فى أي منطقة من العالم، فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة هى التعليم وإن كل الدول التى أحرزت شوطاً كبيراً فى التقدم، تقدمت من بوابة التعليم، بل أن الدول المتقدمة تضع التعليم فى أولوية برامجها وسياستها. ومن الطبيعي أن يكون للتحويلات والتغيرات العالمية انعكاساتها على العملية التعليمية فى شتى بقاع العالم باعتباره نظاماً اجتماعياً فرعياً داخل إطار المنظومة المجتمعية الشاملة، أما الجهل فمن أسباب التخلف و الاندثار. من هذا المنطلق قامت عدة دولة متقدمة بالاستثمار في التعليم و جعله مسؤولية وطنية أولى في مراحله الأساسية و لجأت لسياسة التمييز الإيجابي للتغلب على الهوة بين الطبقات المختلفة لمجتمعاتها، التى ستزداد باحتكار التعليم الجيد على أبناء الطبقات الميسورة مما سيؤدى لخلل اجتماعي كبير. و هنا كان التمييز الإيجابي مبني على أساس قاعدة التعويض عن اللامساواة المتجذرة و على مبدئ الإنصاف و ليس العدالة المطلقة في المعاملة. فالتميز الإيجابي يقتضي أن نأسس للحيف من أجل إشاعة العدل. إن أهم الأمثلة و التي يمكن القياس عليها في مجال التعليم، هو المثال الفرنسي، حيث نشأت فكرة التمييز الإيجابي في مجال التعليم في ستينيات القرن الماضي و ذلك بعد أن أثبت الباحثون وجود علاقة بين مستوى التحصيل عند التلاميذ و جذورهم السوسيو اقتصادية. و حينها بدأ التفكير لتلافي الإختلالات التى قد تحدث نتيجة لتأثير تلك الظروف على أطياف من المجتمع الفرنسي. و لقد وردت أول الإشارات لضرورة التمييز الإيجابي في مجال التعليم في المقولة الشهيرة للمفكر الفرنسي Bertrand Shwartz (إذا كان للمدرسة أن تعوض آثار مجتمع غير عادل، فلا بد أن تكون هي نفسها غير عادلة)، انتهى الاستشهاد. و قد تم في سنة 1981 ترسيم نظام التميز الإيجابي في بعض المؤسسات التربوية الفرنسية. نعم لقد صدق Bertrand، فدور المدرسة هو إذابة الفوارق بين المتعلمين لا تكريسها، كما تفعل المدرسة الموريتانية اليوم. فهناك مدارس النخبة ببرامجها الخاصة و إمكاناتها الكبيرة و مدارس الفقراء (لحراطين غالبا)، حيث الإهمال و التسيب مع تدهور البرامج و انعدام أبسط الوسائل العصرية. هذه الوضعية حولت المدرسة النظامية من مؤسسة تربوية الى مفرزة للفشل و التسيب و صناعة الانحراف. إن التفاوت آنف الذكر ليبين مدى عدم التكافؤ فى فرص تعليم جيد مما سيؤدي لتمايز صارخ في الحصول على عمل بعد التخرج. فالأمر هنا لا يتعلق بالمهارات الفردية، بقدر ما يتعلق بإمكانية تعويض الفرص الضائعة. فالأطفال المنحدرون من أوساط معينة يمكنهم تعويض نواقص المدرسة بالاعتماد على الأب أو الأم أو عن طريق الدروس الخصوصية أو ساعات التقوية بينما لا تتاح هذه الفرصة لأطفال الأوساط المهمشة. مالذي يمكن فعله إذا لضمان الإستفادة القصوى للطبقات المهمشة من التعليم في بلادنا؟ الجواب بالطبع هو اتخاذ إجراءات تفضيلية في مجال التعليم للفئات المهمشة من أجل تعويض التفاوت في الوسائل و الإمكانيات. هذا هو دور الدولة، التى يجب أن ترعى الجميع و تحنو على الضعيف. إننا ننتظر من موريتانيا 2014 أن تقوم بما قامت به فرنسا عام 1981، حيث أقرت مبدأ التمييز الإيجابي في مجال التعليم. إن القرار المنتظر يجب أن يحدد المعاير التى يجب إتباعها فى تحديد المؤسسات و المناطق التى يجب أن تخضع للتمييز الإيجابي في مجال التعليم، و من الواضح هنا أنني لا أركز على الأفراد و ذلك لإصراري على ضرورة استفادة كل المهمشين مهما اختلفت مشاربهم. أريد هنا أن أستبق الأحداث لأحدد ملامح المناطق و المؤسسات التي يفترض أن تخضع للقانون المنشود و سأطلق عليها تسمية "المناطق ذات الأولوية في التعليم". حسب رأي المتواضع يجب أن تدخل كل تجمعات آدواب تحت هذا المسمى و كذلك كل المؤسسات التعليمية الواقعة في أحزمة الفقر حول المدن (مناطق الترحيل). قد يقول قائل و ماذا بعد التسمية؟ و هو سؤال وجيه، لكن الرد عليه سيكون كالتالي: إن إقرار سياسة التمييز الإيجابي يتطلب إصلاحا تعليميا جديدا يأخذ في الاعتبار ترقية التعليم العام من حيث المناهج والمصادر البشرية و البنى التحتية من أجل تهيئة المناخ لتصنيف المؤسسات التعليمية. فالتعليم العام عندنا يعاني من ترهل و فساد يجب وضع حد لهما قبل الحديث عن أي تمييز إيجابي. إن نجاح السياسة المقترحة سيتطلب ما يلي: • يجب أن تحصل كل المؤسسات الواقعة في حيز "المناطق ذات الأولية في التعليم" على مخصصات مالية إضافية و على عدد أكبر من المصادر البشرية كما يجب تقديم حوافز تشجيعية للأفراد العاملين بها. • يجب تطبيق سياسة صارمة فيما يخص إلزامية التمدرس. • يجب إعادة العمل بنظام الحضانة بمفهومها القديم (الغذاء و السكن و الدواء و مبلغ مالي بسيط)، بنفس المؤسسات، خاصة في المستوى الإعدادي و الثانوي و الجامعي. • يجب أن يستفيد تلاميذ تلك المدارس من التوزيع المجاني للوازم المدرسية. • يجب أن تتطلع المؤسسات الواقعة في نطاق "المناطق ذات الأولوية في التعليم" بدور تحضيري لتلامذتها من أجل المشاركة و التفوق في المسابقات الوطنية (إعطاء دروس خصوصية أو دروس التقوية). • يجب أن تدفع الدولة علاوة جزافية لكل الآباء من ذوي الدخل المحدود (يحدد السقف و عدد الأطفال) و ذلك عند افتتاح السنة الدراسية. إنني متأكد أن الكثيرون سيرفضون هذا الطرح و ذالك لاعتقادهم أن أسباب فشل أبناء أطفال الفئات المهمشة يعود لأسباب تتعلق بأوساطهم الإجتماعية و ليست لها علاقة بالمؤسسات التربوية. لأولئك أقول إن نظريتكم خاطئة، كما يرى Bernard Charlot. لأن السؤال الذي يجب أن نطرحه ليس لماذا يفشل أبناء المهمشين في المدرسة؟ بل لماذا ينجح أبناء الميسورين؟ السبب كما ذكر آنفا يرجع للفرص المتاحة لهؤلاء لتعويض جوانب القصور لدى المدرسة سواء كانت بنوية أو ذات علاقة بالتأطير و هذا ما يبرر حاجتنا لتبني سياسية التمييز الإيجابي في مجال التعليم. إن الحرص على تطبيق هذه السياسة ينبع من قلقنا على مستقبل أبناء هذا البلد الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الاستراتيجي للأمة الموريتانية التى من حقها أن تقف معتدلة وأن تمشي مستوية لا عرجاء بسبب ضعف أحد أركانها. أنه بكل تأكيد ليس حلا سحريا يمكنه أن ينقذ كل أبناء المهمشين من الضياع لأنه لكل شيء نقاط قوة كما له نقاط ضعف، لكنه سيولد الأمل لدى العديد من الموريتانين و يشعرهم بأن الذين ارتقوا سلم العلم مستعدون أن ينزلوه ليستفيد منه غيرهم بدل أن يسحبوه معهم نحو الأعلى. يتواصل
الصفحة الأساسية > آراء حرة > لا شيء يفوق العدالة سوى الإنصاف
لا شيء يفوق العدالة سوى الإنصاف
الاثنين 19 أيار (مايو) 2014 05:00

سيد أحمد ولد محمد






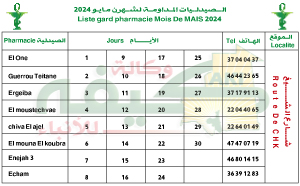

» آخر التعليقات
-
22 أيار (مايو) 2024 الساعة 06 و51 دقيقة
ابن كيفه العطشا نه : طبعا لا هذي أسرارالمهنه -
22 أيار (مايو) 2024 الساعة 05 و08 دقيقة
ابن كيفه العطشا نه : يجب على المتضررين القيام بالمبادره بالا حتجاج السلمي والتعبير عن (...) -
20 أيار (مايو) 2024 الساعة 08 و30 دقيقة
ابن كيفه العطشا نه : انها أموال الشعب المنهوبه منه بل المغتصبه منه يراها عند الآ خرين من ليس لهم الحق فيها (...) -
20 أيار (مايو) 2024 الساعة 05 و55 دقيقة
ابن كيفه العطشا نه : كيف يأتون يفسائل من آخر الدنيا وبالقرب منهم الجزائر الشقيقه وتونس ولديهم أفضل (...) -
18 أيار (مايو) 2024 الساعة 07 و16 دقيقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مادام لهم مسكن لائق كمثل دار تتالف من 2 او 3 بيوت (...)
» قناة كيفة انفو
» الظوال
- 2023/11/13 وكالة كيفه في جولة جديدة مع اظوال ( معلومات وهواتف)
- 2023/11/1 وكالة كيفه في جولة جديدة مع اظوال ( معلومات وهواتف)
- 2023/10/5 وكالة كيفه في جولة جديدة مع اظوال ( معلومات وهواتف)
- 2023/04/27 وكالة كيفه في جولة جديدة مع الظالة ( معلومات+ هواتف)
- 2023/02/2 وكالة كيفه في جولة جديدة في "أظوال"(معلومات وهواتف )
- 2022/12/10 وكالة كيفه في جولة جديدة في "أظوال"(معلومات وهواتف )
» أسعار الحيوان
الإبل
- الدك: 140 ألف أوقية
- أشوايل 500 ألف أوقية
- آزوازيل 450 ألف أوقية
البقر
- آوداش 350 ألف أوقية
- الجدعات لمكاريب 190 ألف أوقية
- أفوك 80 ألف أوقية
الغنم
- أقيار 20 ألف أوقية
- الرخله 38 ألف أوقية
- الكبش المتوسط 40 ألف أوقية
» أعلام
-
 شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
-
 كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
-
 الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
-
 لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
-
 مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار
مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار





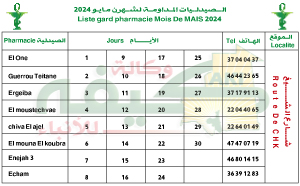

» آخر التعليقات
-
22 أيار (مايو) 2024 الساعة 06 و51 دقيقة
ابن كيفه العطشا نه : طبعا لا هذي أسرارالمهنه -
22 أيار (مايو) 2024 الساعة 05 و08 دقيقة
ابن كيفه العطشا نه : يجب على المتضررين القيام بالمبادره بالا حتجاج السلمي والتعبير عن (...) -
20 أيار (مايو) 2024 الساعة 08 و30 دقيقة
ابن كيفه العطشا نه : انها أموال الشعب المنهوبه منه بل المغتصبه منه يراها عند الآ خرين من ليس لهم الحق فيها (...) -
20 أيار (مايو) 2024 الساعة 05 و55 دقيقة
ابن كيفه العطشا نه : كيف يأتون يفسائل من آخر الدنيا وبالقرب منهم الجزائر الشقيقه وتونس ولديهم أفضل (...) -
18 أيار (مايو) 2024 الساعة 07 و16 دقيقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مادام لهم مسكن لائق كمثل دار تتالف من 2 او 3 بيوت (...)
» قناة كيفة انفو
» الظوال
- 2023/11/13 وكالة كيفه في جولة جديدة مع اظوال ( معلومات وهواتف)
- 2023/11/1 وكالة كيفه في جولة جديدة مع اظوال ( معلومات وهواتف)
- 2023/10/5 وكالة كيفه في جولة جديدة مع اظوال ( معلومات وهواتف)
- 2023/04/27 وكالة كيفه في جولة جديدة مع الظالة ( معلومات+ هواتف)
- 2023/02/2 وكالة كيفه في جولة جديدة في "أظوال"(معلومات وهواتف )
- 2022/12/10 وكالة كيفه في جولة جديدة في "أظوال"(معلومات وهواتف )
» أسعار الحيوان
الإبل
- الدك: 140 ألف أوقية
- أشوايل 500 ألف أوقية
- آزوازيل 450 ألف أوقية
البقر
- آوداش 350 ألف أوقية
- الجدعات لمكاريب 190 ألف أوقية
- أفوك 80 ألف أوقية
الغنم
- أقيار 20 ألف أوقية
- الرخله 38 ألف أوقية
- الكبش المتوسط 40 ألف أوقية
» أعلام
-
 شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
-
 كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
-
 الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
-
 لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
-
 مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار
مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار
الأخبار
قضايا
تحاليل
تقارير
آراء حرة
اصدارات
مقابلات
أعلام
هواتف تهمك
منبر كيفة
أخبار الجاليات
الظوال
أسعار الحيوان
صور من لعصابه
قسم شؤون الموقع والوكالة
تراث
دروس
كاريكاتير
نساء لعصابه
قناة كيفة انفو
سوق كيفة
جميع الحقوق محفوظة لـ " وكالة كيفة للأنباء" - يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من الوكالة ©2014-2016






 منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
 ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟
ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟