رحل يحي جامى "رجل غامبيا القوي"، وسيرسله التاريخ إلى ما وراء النسيان، كما فعل مع جميع أقرانه، رحل كما رحل الذين من قبله، موبوتو وبوكاسا وتيتو وستالين وهتلر وموسوليني وماو تسي تونغ وباتيستا وفرانكو وسالازار وهابري وماركوس وبينوشيه وكاسترو وغباغبو وبن علي ومبارك والقذافي، وكل أولئك الرجال الذين ابتلعهم الزمن، بعدما ظن الناس يوما، بأن العالم لا يستغني عنهم أبدا،
في المقابل حفر التاريخ أسماء آخرين في ذاكرته ورصعها بالذهب، سقراط وغاليليو وغاندي ومانديلا وديغول وأبراهام لنكولن ومارتن لوثر كينغ ولومومبا وسنغور وتشي جيفارا ومهاتير محمد وسعد زغلول وعبد القادر الجزائري وعمر المختار والسيد قطب وعز الدين القسام وكين سارو ويوا وسميدع وفاضل أمين وغيرهم كثير،
اتقوا شر التاريخ، فهو يعرف تماما، كيف ينتقم من الضحالات والمستنقعات التي تنمو على حافاته، وكيف يحول العمالقة الذين يمرون به، إلى مزارات حقيقية،
(المقابر مليئة برجال لا غنى عنهم)، هي مقولة للعملاق شارل ديغول، لم يتفق الفرنسيون، هذا الشعب المتأفف بطبعه والذي يهتم بالتفاصيل لدرجة الضجر، على شيء، مثلما اتفقوا على عشق الثقافة والطبخ والجبنة العتيقة والجنرال ديغول،
ولكي يصبح ديغول، أحد مزارات التاريخ الفرنسي والإنساني، كان عليه أن يضع المفتاح مرتين تحت الباب:
الأولى، كانت في خريف عام 1940، حين سقطت فرنسا في يد النازيين، كان يمكن لديغول يومها أن يحصل على حقيبة وزارية مريحة في حكومة فيشي، التي شكلها المارشال فيليب بيتان، لكن الرجل انحاز لوطنه، فوضع المفتاح تحت الباب ورحل إلى المجهول!
الثانية، كانت بعد أحداث مايو 1968، كان صاحب القامة السامقة والأب الروحي للجمهورية الفرنسية الخامسة، في أوج عطائه السياسي ولديه من الأسباب الكثير ليبقى في السلطة، لكنه انحاز لشعبه، وضع المفتاح تحت الباب مرة أخرى ورحل إلى منزله الريفي في بلدة كولومبى الهادئة، دون أن يصطحب معه "صندوقا" واحدا، ففي فرنسا، الصناديق الوحيدة التي يتعاملون بها هناك، هي صناديق الاقتراع!
تحول الجنرال والمقاوم والرئيس إلى مواطن فرنسي عادي، يلقي تحية الصباح على المارة ويشتري الخبز من الفرن المجاور، حتى أنه عندما أراد أن يوسع حديقة بيته، كان يقايض جاره العجوز، "مترا بمتر وسياجا بسياج"!
لا أشك لحظة واحدة، في أن الإخوة في غامبيا أضاعوا وقتا طويلا وهم يطرحون على أنفسهم ذلك السؤال "الفجيعة": من يستطيع أن يملأ الفراغ ويخلف جامى، إن هو غادر السلطة؟، ذات السؤال الذي طرحناه نحن على أنفسنا مع كل نظام استثنائي، وهو نفس السؤال الذي تطرحه كل الشعوب المغلوبة على أمرها، عندما يتعفن أحدهم في الكرسي ويكتم على أنفاسها،
فالأنظمة الأحادية والاستبدادية توهم شعوبها بأن هي التاريخ، منها يبدأ وإليها ينتهي، وبذلك تصبح هي الماضي والحاضر والمستقبل الوحيد، المسموح لتلك الشعوب بالتفكير فيه، ولأن الكذبة كبيرة جدا تنتهي تلك الأنظمة نفسها بتصديق هذا الهراء، وهكذا تكون نهاياتها دائما مدوية وبائسة وتتفطر لها القلوب،
لو لم يهتد ديغول إلى أن "المقابر مليئة برجال لا غنى عنهم"، لما أدرك في الوقت المناسب أن فرنسا استغنت عن خدماته ولم تعد بحاجة إليه وأن عليه أن يحزم أمتعه ويغادر مصحوبا بكرامته إلى منزله الريفي، لا أحد يستطيع أن يقف في وجه حركة التاريخ،
وهو يحتضر، كان شافيز يصيح في أطبائه ألا يتركوه يموت، وقبل ذلك بسنوات طويلة قرر البلاشفة أن يحتفظوا بزعيمهم لينين، حنطوه وخصصوا له بندا ثابتا في الميزانية السنوية للاتحاد السوفيتي، في كلتا الحالتين لم يعر التاريخ اهتماما لهذا العبث والعقم الفكري، بل استمر في مسيرته وظل يصنف الرجال الذين صادفهم في طريقه، فمنهم من تحول إلى معالم بارزة في ذاكرة الإنسانية ومنهم من أرسله التاريخ إلى منافي بعيدة عن الذاكرة،
غاليلو، الذي لم يكن له من أنيس في وحشة السجن سوى منظاره، هو من قال للكنيسة وهي تحاكمه بتهمة الهرطقة، لأنه برهن على أن الأرض تدور حول الشمس، قال لها عبارته الشهيرة: "إنها تدور رغم أنوفكم"، وما لا يدركه الكثير من الحكام وبطانتهم إلا بعد فوات الأوان، هو أنه ليست الأرض وحدها هي التي تدور رغم أنوفهم، بل والسلطة أيضا،
فلو دامت لغيرهم...ما آلت إليهم.













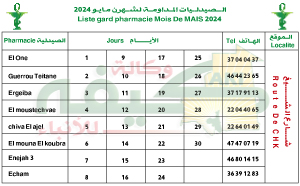

 منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
 ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟
ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟
 شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
 كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
 الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
 لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
 مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار
مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار