مثل مجيئ المدرسة العسكرية لمدينة كيفه مكسبا كبيرا للساكنة وإضافة نوعية هامة،ففضلا عما تضخه هذه المؤسسة من أموال في السوق المحلية عبر الكثير من النفقات فقد آزر أفرادها السكان في عدة مناسبات وبعثت الطمأنينة في نفوس الناس الذين هم بحاجة إلى ما يعزز أمنهم وسكينتهم.
وتطورت الحميمية بين هؤلاء المواطنين والمدرسة بشكل سريع حيث شارك الجنود في حملات تنظيف المدينة وفي التبرع بسخاء بدمائهم للمرضى وتدخلوا في بشكل رائع ذات يوم عندما اشتعلت النيران بالمحطة المركزية للكهرباء قبل سنتين فرموا بأنفسهم في اللهب وتمكنوا من إطفاء ذلك الحريق قبل أن تحدث الكارثة ،وهب هؤلاء البواسل فساعدوا في إطفاء الحرائق التي شبت في المراعي فكسبوا حب العامة واحترامهم.
وفي لقاء حميمي سنوي كانت هذه المدرسة تدعو المئات من سكان المدينة من أطر وأعيان ووجهاء وممثلين للمنظمات الأهلية و صحافة محلية لحضور حفل تخرج دفعاتها في تظاهرة بهيجة وفاخرة يلتحم فيها المواطنون بجيشهم مما يوطد الحب والتعلق به ويشعر الأخير بأنه خلق لخدمة هؤلاء الحضور فما الذي تغير؟
لقد تراجع ذلك الأداء بشكل لافت ومثير للكثير من الأسئلة وانتهى فيما يبدو زمن الوصل بين الأهالي وهذه المدرسة. فخلال الأيام القليلة الماضية نظم الحفل السنوي واقتصرت الدعوات على قليل من الرسميين مما حول الحفل إلى مناسبة باهتة وإلى عمل عسكري بحت.
فهل كانت المدرسة العسكرية بنهجها القديم تخرج على المرسوم في الأعراف العسكرية بحيث يجب أن تبقى جسما غريبا على السكان وجهازا متقوقعا على نفسه لا يعنى بشؤون المدنيين ولا يسأل عنهم ، أم أن الأمر يتعلق فقط بأسلوب كل قائد وفهمه للأمور وطريقته في العمل ؟













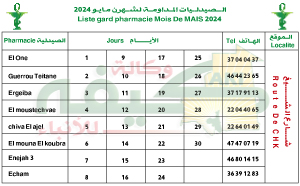

 منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
 ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟
ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟
 شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
 كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
 الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
 لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
 مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار
مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار