هو محمد سالم ولد ميلاه؛ولد سنة 1935 ببلدة "المينان" بولاية تكانت من أم موريتانية هي أميلمنين بنت فيدار وأب فرنسي يدعى ميلاه كان يقود حامية لجيش المستعمر تسند إليها مهمة أمن الشمال الموريتاني.
تربى في أحضان أمه وأخواله فقد أبعد والده إلى سنلوي ومنها إلى فرنسا بعد إشهاره للإسلام إذ لم يرق ذلك لزملائه المستعمرين بحكم أهمية وحساسية وظيفته العسكرية.
علمت الأم أميلمنين بأن الحكام الفرنسيين يطلبون ابنها للدخول في المدرسة فهربت به إلى "أوكار": واختفت هناك قبل أن تهتدي إليها عيون الفرنسيين الذين يصممون على تعليم الطفل الذي تربطهم به علاقات خاصة.
فقام الوالي الفرنسي بتكانت بإرساله صحبة والدته إلى تامشكط ومن ثم إلى مدينة لعيون وبعد ذلك أرسل إلى مدرسة "ابناء الشيوخ " في تنبدغه سنة 1944
أنهي محمد سالم دراسته الابتدائية في هذه المدرسة
 وقد كان على درجة عالية من الذكاء فكان في مقدمة الناجحين.
بعدها أرسل لينضم إلى الثانوية الفنية بسنلوي السينغالية فتخرج منها حاملا شهادة في التخطيط عام 1957.
وبعد عودته أختير فورا ضمن فريق فني لتخطيط العاصمة الموريتانية انواكشوط .
وقد كان على درجة عالية من الذكاء فكان في مقدمة الناجحين.
بعدها أرسل لينضم إلى الثانوية الفنية بسنلوي السينغالية فتخرج منها حاملا شهادة في التخطيط عام 1957.
وبعد عودته أختير فورا ضمن فريق فني لتخطيط العاصمة الموريتانية انواكشوط .
ذهب محمد سالم في دورات تدريبية في عدد من دول العالم تحول خلالها إلى مجال المياه الذي برع فيه وهو ما جعل السلطات الموريتانية توظفه بعيد الاستقلال في مهمات عديدة داخل مدن البلاد تنقيبا وحفرا ، ثم عين رئيسا للمصلحة الجهوية للمياه في عدد من ولايات الوطن منها أطار ولعيون ثم كيفه التي استقر بها حتى تقاعد وفيها تزوج وانجب أولادا وفيها اختار المقام حتى اليوم.
تزوج صاحبنا سنة 1978 من السيدة أخويديجه بنت البخاري التي كان ذووها في بادية كيفه وبالذات في بلدة "لمصيرطه" التابعة لبلدية الملكه.
 وهناك كان محمد سالم يأخذ كافة عطله وأيام راحته فهو مأخوذ بالطبيعة وعالم الريف، ثم قام باستصلاح أرض واسعة في هذا المكان وإليها جلب مختلف وسائل وأدوات الري وحفر عدة آبار .
وهناك كان محمد سالم يأخذ كافة عطله وأيام راحته فهو مأخوذ بالطبيعة وعالم الريف، ثم قام باستصلاح أرض واسعة في هذا المكان وإليها جلب مختلف وسائل وأدوات الري وحفر عدة آبار .
وبأسلوب علمي أقام مزرعة نموذجية ضخمة للخضروات ومختلف الأشجار المثمرة فكانت أكبر ما عرفه الجنوب الموريتاني وكان يشرف بنفسه على العمال و الري فكانت المحاصيل كبيرة ولعدة سنوات كانت السيارات تشحن من حقله فأكل وأكل الناس وخزن وباع.
لقد أكد في حواره مع وكالة كيفه للأنباء أنه مغرم بالعمل والإنتاج وأن ذلك هو معنى أن نحيي وهو الإيمان الذي دفعه رغم وظيفته المدرة ووضعه المعيشي المريح إلى إنجاز هذا المشروع رغبة في إطلاق ثورة زراعية في المنطقة ونشر الوعي بين السكان بضرورة العمل ونبذ الكسل والاتكالية.
ولقد عمرت مزرعة محمد سالم كثيرا إذ أطلقها عام 1978 واستمرت حتى 1994 حيث أصيب صاحبنا بوعكات صحية متتالية أدت إلى ضعف جسمي تواصل ولم يعد بمقدور محمد سالم المواصلة في ذلك العمل.
 كان محمد سالم رجلا كريما ومضيافا وكان محبا للناس مستعدا لمؤازرتهم في أي وقت وطبعت مأموريته على مصلحة المياه بولاية لعصابه الكثير من الجدية والحيوية والاستعداد وفي عهده أقيمت مشآت مائية كثيرة وتم التنقيب في مختلف أنحاء الولاية وظل مثالا للموظف الملتزم المواظب العادل بين كافة المواطنين.
كان محمد سالم رجلا كريما ومضيافا وكان محبا للناس مستعدا لمؤازرتهم في أي وقت وطبعت مأموريته على مصلحة المياه بولاية لعصابه الكثير من الجدية والحيوية والاستعداد وفي عهده أقيمت مشآت مائية كثيرة وتم التنقيب في مختلف أنحاء الولاية وظل مثالا للموظف الملتزم المواظب العادل بين كافة المواطنين.
وبعد التقاعد اعلن محمد سالم تطوعه للتنقيب فصار يستجيب لكل من يطلب منه ذلك.
اختار محمد سالم البقاء في باديته "لمصيرطه" التي تشهد كل الآثار التي لاحظناها بحدوث نهضة زراعية حقيقة وبجود إنسان قهر كل الصعاب وتغلب عل كافة المشاكل حتى وصل إلى هدفه المتمثل في الانتاج والخلق والاعتماد على النفس والعمل على ما ينفع الناس جميعا ويمكث في الأرض.
سألناه إن كان يهتم بالسياسة فأجاب بلا ، مستطردا ولكني أصوت بعذ أن أجتهد أي المترشحين أفضل.
لقد أصر هذا الرجل الذي بلغ من العمر عتيا ولم يعد بمقدوره العمل أن يتمسك بعنوان الإرادة وأن يعض بالنواجذ على ما يراه سبيلا وحيدا لتقدم هذا البلد واكتفاء أهله واستغنائهم عما وراء البحار، فأقام بمساعدة عياله حديقة صغيرة عند باب العريش الذي يقطنه وهناك تحمل إليها المياه عبر عربة يجرها حمار من مسافة تتجاوز 400م .
لم تسدي الدولة معروفا لهذا "الإنسان" بعد تقاعده سواء تعلق ذلك بالناحية المادية أو المعنوية ولم يزره من يسأل عن حاله من الرسميين رغم ما تقوم به الدولة من تكريم واستحضار لأشخاص لم يفعلوا في حقها عشر ما قام به الرجل. مندوب والوكالة طلب إليه إن كان يريد تقديم نصيحة للسكان فقال: "أوصيهم بالتأخي والوحدة والعمل".

في الحديقة الصغيرة يجلس الوالد "محمد سالم " في ساعات الصباح و في الأصيلال يستنشق الهواء العليل و ويتمتع بالنظر إلى الزهور وأكمام النباتات وهي يانعة وهو يتذكر حياة حافلة بالعطاء والنشاط، حياة سخرها في خدمة المجتمع والدولة ويندب أيام القوة والعزة والخلق، مقدما الدروس الرائعة في الجد والصبر والتعلق بالحياة مهما كانت التحديات و المثبطات والنوائب.
يجلس محمد سالم ولد ميلاه في حديقته المنزلية يوزع نظرات غائرة في الزمن كأنما يردد في صمت أبيات أبي العتاهيه:
بكيْتُ على الشّبابِ بدمعِ عيني*** فلم يُغنِ البُكاءُ ولا النّحيبُ
فَيا أسَفاً أسِفْتُ على شَبابٍ*** نَعاهُ الشّيبُ والرّأسُ الخَضِيبُ
عريتُ منَ الشّبابِ وكنتُ غضاً*** كمَا يَعرَى منَ الوَرَقِ القَضيبُ
فيَا لَيتَ الشّبابَ يَعُودُ يَوْماً*** فأُخبرَهُ بمَا فَعَلَ المَشيبُ

















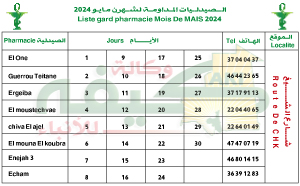

 منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
 ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟
ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟
 شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
 كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
 الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
 لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
 مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار
مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار