يطرح نهوض الإسلاميّين الجدد مع الربيع العربي مشاكل جوهريّة، تكمن في احترام أسس العقد الاجتماعي والدولة اللذان يمكّنانهم من التعبير عن آرائهم والوصول إلى البرلمانات والسلطة التنفيذيّة. ففي تونس ومصر كما في كردستان العراق وغيرهم، هناك مزج بين شرعيّة هذه التيارات وبين حقّها في تغيير أسس الديموقراطيّة والمواطنة. في ظلّ صمت هذه التيارات حول الالتباس الخطير.
لا يدخل الإسلاميون مجالات السلطة العامة والحكم في أكثر من بلدٍ عربي في ظرف انتقال طبيعيّ؛ والمقصود هو ظرف انتقالٍ للسلطة التنفيذيّة من تيارٍ سياسيّ أو حزبيّ إلى آخر، كما يجري عادّة في البلدان العريقة بالحياة الديمقراطيّة؛ حيث تشكّل جملة الأعراف والدساتير والقوانين والقيم العامة والعقود الاجتماعية، الضابط والحكم والمؤشّر لطبيعة ذلك الانتقال. ما يجري في حالات هذه البلدان هو شيءٌ خاصّ. فما يتحوّل ويتغير ليس القائمون على السلطة والشؤون العامّة فحسب، بل جلّ تلك الأعراف والدساتير والقوانين والقيم والعقود العامّة التي تنظّم مظلّة الحياة العامة في هذه البلاد. وما يزيد تكريس خصوصيّة هذه الحالة، هو بالضبط الفهم والوعي الخاصّ الذي يملكه الإسلام السياسيّ لجملة تلك المفاهيم.
لم يأخذ الإسلاميّون المصريّون أيّ موقف من الحكم على عادل إمام
بعد مرور أكثر من شهرين على تأكيد محكمة مصرية الحكم على الفنّان المصري عادل إمام بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، بتهمة الإساءة للدين الإسلامي في أعماله الفنية، لم تعط الأحزاب الإسلامية أيّ رأيٍ بالموضوع. بالرغم من أنّ الكثير من الاحزاب الأخرى أعلنت تنديدها بالحكم الصادر على أمام. فالقضية التي رفعها أحد المحاميين المصرين ضد هذا الفنّان، بدعوى ازدراء الدين الإسلامي في أفلام ومسرحيات مثل "الإرهابي" و"الزعيم" و"مرجان أحمد مرجان" و"حسن ومرقص"، والاستهزاء بالنقاب والجلباب، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية المصريّة، خشية تحوّلها لممارسة تقليدية واعتيادية في القضاء المصري. والاسلاميّون المصريون الذين يشكّلون أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان المصري، لم يسجّلوا أيّ تعليق على هذه القضيّة العامة. تغاضٍ قد قُرأ بمعنى الموافقة والتأييد! [1].
في ذلك الوقت بالضبط، كان زعيم حركة النهضة الإسلامية التونسية راشد الغنوشي، يعطي تصريحاً لإذاعة إكسبريس التونسية بخصوص مجلّة الأحوال الشخصية في تونس [2]. حيث أصرّ الغنوشي على أن الحركة لن تغيّر إلاّ فصلين من المجلة؛ يتعلق الأول بفصل التبنّي، حيث تريد الحركة استبداله بمبدأ "الكفالة"، والفصل الآخر هو تعدّد الزوجات، حيث قال بأن الإسلام لا يمنع تعدد الزوجات ولا يفرضه. جاء حديث السيد الغنوشي بعد أن أكّدت أدبيّات حزب النهضة مراراً بأنّ مجلّة الأحوال الشخصية والقوانين المدنية هي شكل من أشكال الاجتهاد، وأكّدوا مراراً، خصوصاً في فترة معارضتهم لنظام بن علي ومحاولتهم التقرّب من التيارات السياسية التونسية المعارضة الأخرى، بأنّ تعدد الزوجات من "العدل المستحيل".
لم يُعرف بالضبط بأيّ صفة كان الغنوشي يتحدث؛ فهو لا يحتلّ أيّ منصبٍ رسميّ، حتى ضمن حزب النهضة نفسه! كما أنه لم يُعرف فيما يخصّ مجلّة الأحوال الشخصية، التي تشكّل جوهر العقد الاجتماعي المدنيّ التونسي، خاصّة المادتين المذكورتين وهما جوهر هذه المجلة، إن كان يحقّ لحزبٍ سياسيّ أو تيّار إيديولوجي أن يغيرها أو أن يحوّل جوهرها. كما أن الأكثر غرابة، أنّ ذلك الموقف لم يثير ردّات فعل من قبل أجهزة قضائيّة أو تنفيذيّة أو تشريعيّة في تونس؛ في حين يمسّ التصريح بالتشريع في العقود المدنية.
كثير من مثل هذه الأفعال والممارسات تدور في عديد من البلدان التي تجري فيها التحوّلات السياسية الحديثة عقب الربيع العربي. تنظيمات وأحزاب وتيارات سياسية إسلامية، تحمل فهماً ووعياً وممارسات خاصّة بها للقيم التي تضبط العلاقة الثلاثية بين السلطة من طرف والدولة والقوانين والمجال العام من طرف آخر، وتمسّ جوهر قيمها وطريقة توازنها مركز النموذج "الجمهوري" للعقد الاجتماعي السياسي الأعلى. وفي الوقت نفسه الذي كان الغنوشي يدلي فيه بتصريحه، كان متظاهرون أكراد من تيارات سياسيّة دينية في إقليم كردستان العراق، يهاجمون محالاً لبيع الخمور في مدينة أربيل عاصمة الإقليم. جاء هجومهم كردّ فعلٍ غاضب على نشر مجلة "چرپه" الكرديّة الثقافية لموضوع مأخوذ عن صفحة فايسبوك، حيث تمّ اعتبار المادّة الصحفية مسيئة للإسلام والمسلمين. لم تكن ردّة فعل الحكومة في الإقليم إدانة أفعال المهاجمين على محلاّت الخمور، وتقديمهم للمحاكمات الجنائية، كون الفعل الذي قاموا به مخالف للقانون، بغض النظر عن رأيهم بما نشر في الصحيفة. بل أوقفت المجلة وأكّد رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البرزاني بأنّ حكومته تقف بكل قوّة ضدّ أي "استخفاف" بالدين الإسلامي [3]. وفي نفس الوقت بالذات، كانت وزارتا التربية والتعليم العالي التونسية ووزارة الشؤون الدينية توقعان اتفاقاً لإعادة تفعيل التعليم والتدريس الزيتوني (نسبة لمؤسسة "جامع الزيتونة" الدينيّة التاريخية التقليدية). حيث جرى الحفل تحت إشراف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، وعدد من الشيوخ الميّالين سياسيا للحركة، الذين أشادوا بوجود منظومة تعليم دينيّة في البلاد، موازية "للتعليم المدني" الذي يجري منذ عهد بورقيبة !!.
الضبط الثنائي
يعتقد الإسلاميون الجدد، تحت تأثير خطاباتهم الاحتفالية بالوصول للسلطة عبر العملية الديموقراطية، بأن وصولهم هذا واستحواذهم على مؤسّسات السلطة التنفيذية، يمنحهم الحق تماماً بممارسة السلطة بشكلٍ غير مضبوط، أي أن السلطة تتساوى في وعيهم مع الحكم. إلاّ أنّه عدا آلية "فصل السلطات" الثلاث أو الأربع، التي تعدّ الركن الأساس في ممارسة الديموقراطية، هناك ثمة ما أعمق وأشدّ تعقيداً للحياة السياسية والعامّة، في أي بلدٍ يدّعي أنّه يقوم على أساس المواطنة وترتسم مؤسّساته حسب القيم الجمهورية. هذا الشيء العميق غائبٌ تماماً عن الوعي السياسي للحركات الإسلامية الجديدة.
فمن طرف، لا يميّز الإسلاميون الجدد بين مفهومي السلطة والدولة [4]، فما يخولون بممارسته حسب العملية الديموقراطية هي الأفعال والحقوق المنوطة بالسلطة التنفيذية فحسب، وليست التي تعتبر تحديداً وتفصيلاً من ممارسات أجهزة الدولة المختلفة. فما مُنح من حقوق لممارسة السلطة التنفيذية لأيّ طرفٍ سياسيّ، يتمّ حسب جسمٍ وشكلٍ أساس هو الدولة بمؤسّساتها وقيمها والروابط الموجودة بينها. حيث لا يمكن للفرع، المتمثل بالسلطة التنفيذية، أن يغيّر الهيكل الأساسي الذي قامت عليه الدولة. لأنّه في ذلك الحين يهدم الأساس الذي قامت عليه وكسبت الشرعية عبرها. فالسلطة ممنوحة لأنّه ثمة دستور معيّن ومضبوط قد صاغ آليّاتها. دستور نتج عن تفاعلٍ تاريخيّ وذاكرة جماعية ونضالات مشتركة وقيم عالميّة ومكتسبات اجتماعية والكثير من العوامل الأخرى، التي شكلت مجتمعة هذا الدستور، الوثيقة الأساسية لأيّ دولة. ولا يمكن لأيّ حزب حاز على السلطة بفعل حصوله على نصف أصوات الناخبين، أو حتّى أقل، أن يتعدّى على هذه الأسس. والشيء الذي يصحّ على الوثيقة الأساسية للدولة، "الدستور"، يصحّ أيضاً بحقّ المؤسّسات التي صاغها، أي مؤسّسات الجيش والتعليم والنقابات والضمان الصحيّ والقضاء. وما يمنح للسلطة التنفيذية هو فقط حقّ الإدارة وتسيير شؤون محدّدة بالقوانين والأعراف في هذه المؤسسات، أو بعضها. أمّا تغيير بنية ومعاني ومقاصد وجوهر هذه المؤسّسات وغيرها، التي تشكل بنيان الدولة الحديثة، فهو غير منوط بأيّ طرف سياسيّ. ولا يمكن وسم أيّ سلطة تريد التحكّم بالأسس والمؤسّسات إلاّ كونها سلطة استبدادية، حتى لو كانت مفروزة حسب عملية "ديموقراطية".
ما يزيد من تأثير ذلك الخلط هو أنّ الأنظمة السياسية السابقة كانت تمارس بشكلٍ مقصود استحواذاً على الدولة. فهي خلّفت من جهة نظاماً سياسياً عاماً خالياً من أيّ عرف ونمط في التفكير السياسي يفصل بين الأمرين؛ ومن جهة أخرى جعلت بنى الدولة مترهلة، تحتاج لإعادة بناء وتأهيل، وهو شيء سيزيد من دور السلطة الحاكمة راهناً، وتأثيرها على تشكيل هذه المؤسسات الخاصة بالدولة. ولا يجب أن يغيب عن المتابعين لخطابات الإسلاميين ضرورة احترامهم للدستور وللعقد الاجتماعي الأساسيّ.
الشيء الآخر غير المدرك في الوعي السياسي للتيارات الإسلامية الجديدة، هو التمييز الواجب بين السلطة السياسية في الأجهزة التنفيذية وبين سلطة الهيمنة على الحقل العام. فمجموعة المعطيات التي تشكل الحقل العام، من المساوة بين الجنسين والمساواة بين جميع الأفراد على أساس المواطنية وحرية التعبير وإبداء الرأي والنشر والتجمهر وتأسيس المؤسّسات إلى الحريات الجنسيّة والشخصية والعقائدية، التي على أساسها يتمّ التفاعل بين جموع المواطنين لا يمكن مسّها أو الإنتقاص منها بأيّ ظرفٍ من الظروف، وتحت أيّ تفسير خاصّ سياسيّ أو ثقافيّ أو دينيّ للمعاني. فهذه الحقوق مكتسبة ومشرعنة عبر نضالات طويلة، ساهمت وتعاضضت من أجلها مفاعيل إنسانيّة شتى. فكما لا يحقّ لأيّ نظامٍ ديموقراطي أوروبي حديث مثلاً أن يعيد تشريع أيّ قانون يبيح الاستعباد أو العنصريّة أو الكراهية، فأنّه لا يمكن لأيّ تيارٍ سياسيّ أن يحتكر معنى الدين وتفسير القيم وتحديد الحياء العام، كما كانت الأنظمة الاستبدادية السابقة تحتكر تعريفات الوطنيّة والانتماء والمقاومة. كما أن أيّ مسّ جوهري بمؤسّسات ومواثيق الدولة يعتبر فعلاً استبدادياً، حتّى لو صدر عن سلطة منتخبة "ديموقراطياً". بالضبط هذا الخلط هو الذي يجري في حالة تونس.
إنّ عدم احترام وضمان أيّ سلطة سياسية للحقل العام وخواصه، ودفاعها عنه وعن المنخرطين به، من أيّ تأثيرٍ عنفيّ أو مؤسساتي يحمل تفسيراته وقيمه الخاصة، كما في المثالين المصري والكردي العراقي، يشكّل في الحقيقة ممارسة تناقض قيم الدولة الجمهوريّة العليا التي انتجت المؤسّسات التي مكّنت الفعل الديموقراطي من إفراز هذه السلطة. والحالة الإسلامية تملك خصوصيّة مضاعفة في هذا الحقل، لأنّها أساساً تنظيمات ومجالات سياسيّة تعج بالمفاهيم والرؤى القيميّة، أضعاف ما تستحوذ على مبادئ وبرامج وتصوّرات سياسيّة واقتصاديّة وتنمويّة .
ثمّة معيار بسيط يمكن من خلاله قياس درجة انتظام الاسلاميين الجدد في القيم الجمهوريّة التي يجب أن تنظم الحياة السياسيةّ في بلداننا حديثة الديموقراطية: ألا وهو معيار أن تعني الكلمات والعبارات ما يُقصد منها بالضبط. مثلاً إنّ عبارة "الدولة المدنية" في الوعي السياسي للإسلاميين الجدد تعني أن لا تكون الدولة عسكريّة، أو ألاّ تكون الدولة طائفيّة. لكنّها لا تعني أبداً مرادها الجوهريّ في أسس الدولة. كما أنّ كلمة "الأغلبية" بالنسبة لهؤلاء الإسلاميين الجدد تعني في الكثير من البلدان التي بها تنوّع طائفي أو مذهبيّ، الأغلبيّة الدينيّة أو الطائفيّة أو المذهبيّة الشاقولية، ولا تعني الأغلبية السياسيّة الأفقية. وكذلك عبارات العدالة والمساواة والحقوق الفردية وحريّة المعتقد ..إلخ.
فهل يأتي هذا لأنّ قيم الدولة الجمهوريّة والإسلام السياسي ينتميان لمنشأين ذهنيين متباينين أساساً؟ ربّما، وربّما لأجل ذلك ثمّة صعوبة في تحوّل الديموقراطية من مجرّد عمليّة انتخابيّة إلى ثقافة وقيم.
رستم محمود / كاتب صحفيّ













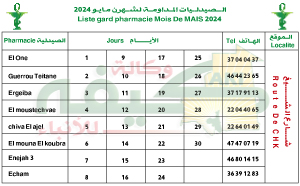

 منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
 ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟
ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟
 شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
 كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
 الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
 لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
 مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار
مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار